بقلم أحمد التوفيق *
اعتبر أبو العباس السبتي أن الإنفاق هو الدليل على أن المنفق قد تخلص من الشرك الخفي الذي يتسرب إلى القلب من حب المال. فمن المعلوم أن التوحيد هو الركن الأعظم في التدين بالإسلام، وشرط الإقرار به شهادة أن لا إله إلا الله، غير أن علماء الدين لم يكتفوا بتلقي ما ورد عن التوحيد في القرآن، بل اجتهدوا في التدليل على وحدانية الله بالعقل، واستندوا على الخصوص إلى ما يسمى ببرهان التمانع، أي أنه لو كان في الأرض والسموات أكثر من إله لوقع فيها الفساد، وجرت في الموضوع مناقشات في مستوى اللغة والمنطق تناولت ذات الله وصفاته، وذلك في مطارحات يستعصي كثير منها على عامة الناس، في إطار ما سمي بعلم الكلام.
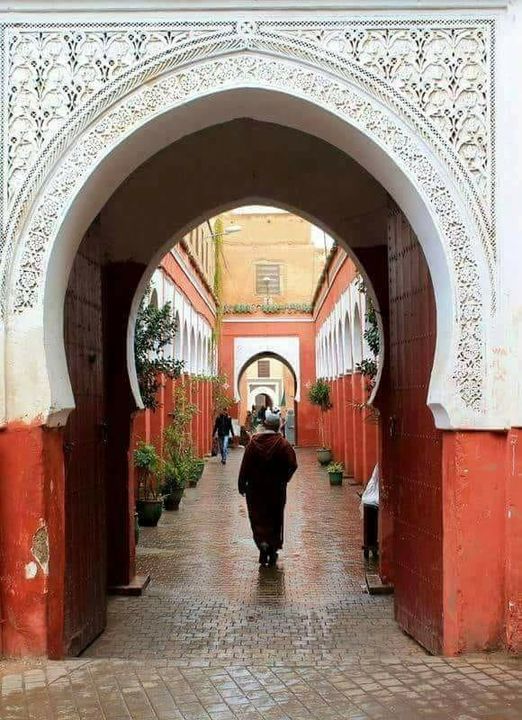 وجرت مقاربة أخرى للتوحيد على أيدي الصوفية، فقد رأى هؤلاء أن حظ عقل الإنسان في إدراك حقيقة التوحيد لا يتعدى تصورات عن الخالق في لغة المخلوق، فقالوا إن ما يمكن تحصيله في هذا الباب إنما يدرك بالذوق، أي بتجربة أو حال روحية على أساس ما ورد في القرآن والسنة عن التزكية، أي التخلص من الهوى المقترن بسلطة الأغيار التي تستولي على النفوس وتسلبها حرية ملامسة المطلق، وقد ذكر الغزالي أن التوحيد أربع مراتب، فالأولى إقرار اللسان مع غفلة القلب، وهو توحيد المنافقين، والثانية إقرار اللسان وتصديق القلب بمعنى اللفظ وهو اعتقاد العوام، والثالثة، أن يرى الأشياء على كثرتها صادرة عن البارئ الواحد، ويحصل ذلك بكشف يوجهه نور الحق، وهو توحيد المقربين، والرابعة، وهي ألا يرى في الوجود إلا واحدا وأن يستغرق بالتوحيد عن النفس والخلق، وهو مقام الصديقين، وهذا لا يعني بأي حال ما يفهم عادة من وحدة الوجود.
وجرت مقاربة أخرى للتوحيد على أيدي الصوفية، فقد رأى هؤلاء أن حظ عقل الإنسان في إدراك حقيقة التوحيد لا يتعدى تصورات عن الخالق في لغة المخلوق، فقالوا إن ما يمكن تحصيله في هذا الباب إنما يدرك بالذوق، أي بتجربة أو حال روحية على أساس ما ورد في القرآن والسنة عن التزكية، أي التخلص من الهوى المقترن بسلطة الأغيار التي تستولي على النفوس وتسلبها حرية ملامسة المطلق، وقد ذكر الغزالي أن التوحيد أربع مراتب، فالأولى إقرار اللسان مع غفلة القلب، وهو توحيد المنافقين، والثانية إقرار اللسان وتصديق القلب بمعنى اللفظ وهو اعتقاد العوام، والثالثة، أن يرى الأشياء على كثرتها صادرة عن البارئ الواحد، ويحصل ذلك بكشف يوجهه نور الحق، وهو توحيد المقربين، والرابعة، وهي ألا يرى في الوجود إلا واحدا وأن يستغرق بالتوحيد عن النفس والخلق، وهو مقام الصديقين، وهذا لا يعني بأي حال ما يفهم عادة من وحدة الوجود.
إن مذهب التوحيد عند السبتي لم يقف عند براهين المتكلمين ولم يتناول أذواق المتصوفين، إذ ربطه بدليل عملي يتجلى في السلوك ويتمثل في البذل والعطاء. لقد استقى هذا المذهب من المنطوق المباشر لآي من القرآن تحمل عادة على أنها تتعلق بأبعاد كمالية للتدين، فقد جاء في القرآن أن الهوى يمكن أن يتخذ إلها، وأن المال الذي يستولي على ضمير الإنسان قد يكون حجابا، لذلك أمر الله رسوله بأن يأخذ من المؤمنين صدقة يطهرهم بها. ولا يتعلق الأمر هنا بالتوحيد الذي يخرج من الكفر، لأن هذا يكفي فيه الإقرار باللسان. ولكنها درجة التوحيد التي تتجاوب مع الفطرة التي فطر الله عليها الإنسان من جهة، والتي بنى عليها سنة الكون من جهة أخرى، فعندما يرى السبتي أن البخل ينطوي على عدم الإقرار بأصل العطاء، يذكر بأن فقر الذين يحتاجون ويبخل عنهم يكاد أن يكون كفرا، فعطاء الله تعالى يسمى رزقا، وعطاء الإنسان مما رزقه الله يسمى إنفاقا، وهو الامتداد الطبيعي لعطاء الله سبحانه، وكل إمساك من قبيل البخل إخلال بهذا القانون، وعطاء الله شامل لكل المخلوقات، وشامل لكل البشر بمقتضى قوله تعالى: “كلاًّ نُمِدُّ هَؤُلاء وَهَؤُلاء مِن عَطاءِ ربِّك”
ولذلك قال أبو العباس لأحد أصحابه: أعط ما عندك لأول من تلقاه، ولو وقع في يد يهودي أو نصراني، فالحركة التي في مقدور الإنسان أن يتشبه في مستواها بالخالق هي الإعطاء، وحيث إن كل ما في الكون ناتج عن مدد الله، فالطبيعة التي خلقها مددا من عنده تتجاوب سننها مع جنس حركتها الأصلية، ومن ثمة يتأتى أن نتصور كيف يمكن أن تكون للكون حساسية لفعل الإعطاء، وحيث إن كمال التوحيد لا يتحقق للإنسان إلا إذا تحققت له الحرية إزاء تملكاته، فكل ما يملكه الإنسان، يوشك أن يقلب هذا المالك مملوكا، وحيث إن التوحيد الإحساني محله القلب كما أن التوحيد في مقام الإسلام محله اللسان، فإن المحل المعرض للفساد بالتملك هو القلب الذي يتسرب إليه الهوى، أما اللسان فمن السهل على صاحبه أن يقول ما لا يصدقه العمل ، هكذا يأتي أبو العباس بالحجج على أن الإنفاق المحسوس هو الدليل الصادق على التوحيد القلبي المعتبر.
بعد أن تعرفنا على شخص أبي العباس، واستعرضنا ملامح مذهبه في التضامن، ورأينا علاقة الجود عنده بالتوحيد، نأتي إلى عرض القراءات الممكنة لهذا المذهب، بحسب فهم وقتنا هذا، وهي قراءات شرعية وصوفية وسياسية واجتماعية وفلسفية،
أولا: القراءة الشرعية،
إن أهم ما يبرز منها يتعلق بترتيب الأولويات، فقد اعتبر أبو العباس أن الإنفاق هو الذي ينبغي أن يكون في مقدمة أعمال التدين،أي أن يعبد الله عن طريق إسداء الخير للغير قبل كل شيء، وبجعل الإنفاق في المركز، رأى أبو العباس أنه وضع الأصبع على عنصر الداء، وكان واعيا بأنه اهتدى إلى فهم في الدين لم يهتد إليه غيره من العلماء، فقد قيل له: لماذا لا تتحدث عن الصلاة، كما يفعل عامة الدعاة ؟ فأجاب بأنه منشغل بالداء الذي عمت به البلوى، ولم يشتغل به غيره من العلماء، وهو البخل الذي هو مصدر الشرور كلها، والعطاء في نظره فاعل في الطرفين ،المعطي والمتلقي، ولولا ذلك لما كانت التزكية بالإعطاء منبت الوازع الذي عليه مدار الطاعة في الدين، بدليل آيات في معنى قوله تعالى:
“وَمَن يُّوقَ شُحَّ نفسه فأُولاَئِك هُمُ المُفلِحون”
إن ترتيب هذه الأولوية يقويه أن قيمة التعبد بالعبادات الأخرى، إنما يصدقه أو يكذبه سلوك المتعبد في باب الإنفاق.
وإذا كان اهتمام أبي العباس مخالفا لما كان يركز عليه الدعاة، فشخصيته كانت مخالفة كذلك، وقد نسبه بعض من راقبوا أحواله إلى الملامتية، وهي الطائفة المعروفة بتجنب ما يجلب المدح، وارتكاب ما يجلب النقد والملامة. وكان يرد على منتقدي أفعاله وأقواله بأن العبرة في حكم الله بما تنعقد عليه الضمائر لا بما يفهم من المظاهر، وجل ما كان يؤاخذ به كلمات واستعارات مأثورة عنه. قال أبو الحسن الصنهاجي، وهو من أصحابه: لما كان ذات يوم عرفة، أراد أبو العباس أن يبين لي فضل ذلك اليوم، فدعاني إلى خارج سور المدينة، فوجدنا باب الدباغين مغلقا، وكانت معي سبعة دراهم، فقال: ادفعها لأول داخل، فدفعتها لعجوز، ودخلنا بحيرة الرقائق، فقال لي أريد أن تنتصب على أربع، فقلت ما هذا الكلام؟ قال أمرتك بعادتك في الصلاة، فاستقبلت القبلة وركعت، فلما فرغت، قال: مرحبا بك يا قران، فاستنكرت كلامه، وقال: لأنك قرنت بين الصدقة والصلاة، قال: قل ما في نفسك فيما يخصني، فقلت: تمر بالمساجد ولا تصلي، فقال: في الحديث أئمتكم شفعاؤكم، قلت: تقول للناس: يا تيوس وهي فحول الماعز، قال لأن الناس يشبهونها في حب التقدم والظهور، قلت وتقول للمخاطب: يا قطيم وهو شديد الشهوة، قال هو عندي الذي يحرص على جمع الدنيا ولا يخرج منها شيئا، فقلت: تأمر الناس بالصدقة، ومن لم يكن عنده شيء تقول له: اجعل على ظهرك أسود، فقلت: هلا قلت له: قم الليل، قال لو قلت له ذلك لدخلني العجب.
هكذا يمثل أبو العباس شخصية غير نمطية تحتج على النفاق الاجتماعي والتكبر المظهري والتزمت الديني. مصداقا للأولوية التي يعطيها للظاهر إذا تعلق الأمر بالعمل وللباطن إذا تعلق الأمر بالنوايا.
ثانيا: القراءة الصوفية،
عاصر أبو العباس شيوخا كبارا في التصوف، ولم يعرف له شيخ في الطريق، ولكن سلوكه ومنظومته الفكرية مما يجعله في عداد رجال التصوف، ومن علامات ذلك قوله بأن العبادة ظاهر وباطن، وتتمثل صلته الأخرى بالتصوف في الحرص على خدمة الناس ومواساتهم، ولكن ربطه العطاء بالاستجابة، وتحقق ذلك بشكل مطرد، يتعدى مستوى الكرامة المعروفة لعامة المتصوفة، ثم إن الذي يعطي لتصوفه بعدا متفردا هو تركيزه على أن العطاء هو الطريق لتحقيق التزكية، أي الشرط العميق للتوحيد، بينما قام منهج معظم الصوفية المربين على جعل الذكر والخلوة والتأمل مرقاة لذلك المقام، فطريقته عملية إذا قورنت بطريقة غيره التي يغلب عليها الاستبطان وما قد يصحبه من التدرج في مسالك النفوس. لقد زار مراكش في الأعوام الأخيرة من حياة أبي العباس المتصوف الأندلسي الكبير محيي الدين بن عربي، ولقي أبا العباس، وفاوضه على حد تعبيره في أمور كثيرة، أي ذاكره، وعجب من أمره، وقارنه بالشيخ عبد القادر الجيلاني، وقال: أعطي السبتي ميزان الجود وأعطي عبد القادر ميزان الصولة، وهذا أتم، لأن السبتي استعجل أن يتصرف بالصدقة، ولو لم يرد شيئا في الدنيا لكان أمره أتم، ولكن مقامه في الذوق كان محمديا. هذا حكم ابن عربي، أما عموم الناس فقد اعتبروا السبتي من أهل الولاية والصلاح، فأدرجوه في الرجال السبعة المخصوصين بزيارة مرتبة في مراكش، ومعلوم أن كل واحد من هؤلاء السبعة إنما عظمه الناس اعتبارا للعمل الجليل الذي كرس له حياته، وعلى سبيل المثال، فالجزولي الذي يأتي بعد السبتي في الزيارة، قد اشتهر بعمل وطني جليل، هو استعمال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في التعبئة لتحرير البلاد من الاحتلال الأجنبي، في بداية العصر الحديث، ولهذا فالتعريف بأمثال هؤلاء العظام، يفيدنا اليوم في إقناع أبنائنا، بأن أجدادهم إنما أقاموا القباب والأضرحة على رجال كرسوا حياتهم لأعمال نافعة، على أساس الإيمان بقيم رفيعة، ولم يبجلوهم من باب الشرك الذي ينسبه لهم البعض ظلما وعدوانا، وعلى العكس من ذلك فهؤلاء كانوا يربون على التوحيد القلبي الحق، وبهذه التوعية، إن جاءت على أيدي العلماء، سينكشف إجرام من يتجرأ على صالحي الأمة بالعداء والبغضاء، وعلى مزاراتهم بالهدم، جناية على الحقيقة والثقافة والتاريخ.
ـ——————————
من درس حسني *